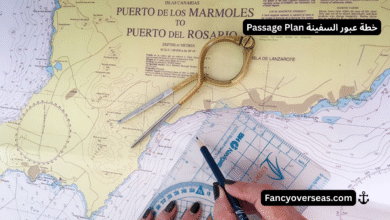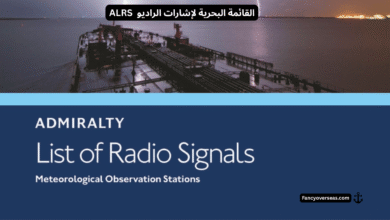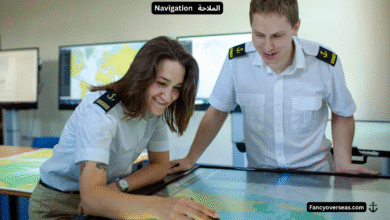المد والجزر (المدر) Tides

المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر هما ارتفاع وانخفاض مستوى سطح البحر الناتج عن التأثيرات المشتركة لقوى الجاذبية التي يمارسها القمر (وبدرجة أقل الشمس)، ويحدثان أيضًا بسبب دوران الأرض والقمر حول بعضهما البعض.
يمكن استخدام جداول المد والجزر لأي موقع لتحديد الأوقات والسعة المتوقعة (أو “نطاق المد والجزر”). تتأثر هذه التنبؤات بعوامل عديدة، منها محاذاة الشمس والقمر، وطور وسعّة المد والجزر (نمط المد والجزر في أعماق المحيط)، والأنظمة البرمائية للمحيطات، وشكل الخط الساحلي وقياس الأعماق بالقرب من الشاطئ (انظر “التوقيت”). ومع ذلك، فهي مجرد تنبؤات، ويتأثر الوقت الفعلي وارتفاع المد والجزر بالرياح والضغط الجوي. تشهد العديد من الشواطئ مدًا شبه يومي – مد وجزر متساويان تقريبًا كل يوم. بينما تشهد مواقع أخرى مدًا نهاريًا – مدًا واحدًا وجزرًا واحدًا كل يوم. “المد والجزر المختلط” – مد وجزر غير متساويين في اليوم – هو فئة ثالثة منتظمة.
يختلف المد والجزر على فترات زمنية تتراوح بين ساعات وسنين، وذلك نتيجةً لعدد من العوامل التي تُحدد الفترة القمرية. ولتسجيل بيانات دقيقة، تقيس مقاييس المد والجزر في محطات ثابتة مستوى الماء بمرور الوقت. وتتجاهل هذه المقاييس التغيرات التي تُسببها الأمواج التي تقل فتراتها عن الدقائق. وتُقارن هذه البيانات بالمستوى المرجعي (أو مستوى البيانات) الذي يُسمى عادةً متوسط مستوى سطح البحر.
في حين أن المد والجزر عادةً ما يكونان المصدر الرئيسي لتقلبات مستوى سطح البحر قصيرة المدى، فإن مستويات سطح البحر تخضع أيضًا للتغيرات الناجمة عن التمدد الحراري والرياح وتغيرات الضغط الجوي، مما يؤدي إلى حدوث عواصف عاتية، وخاصة في البحار الضحلة والقريبة من السواحل.
لا تقتصر ظاهرة المد والجزر على المحيطات، بل قد تحدث في أنظمة أخرى عند وجود مجال جاذبية متغير الزمان والمكان. على سبيل المثال، يتأثر شكل الجزء الصلب من الأرض قليلاً بمد الأرض، مع أن ذلك لا يُرى بسهولة كحركة المد والجزر في الماء.
الخصائص
يحدث المد والجزر في المحيطات دوريًا، حيث يرتفع وينخفض مرتين يوميًا تقريبًا. تُسمى أربع مراحل في دورة المد والجزر:
يتوقف الماء عن الانخفاض ليصل إلى حد أدنى محلي يُسمى الجزر.
يرتفع مستوى سطح البحر على مدار عدة ساعات، مُغطيًا منطقة المد والجزر؛ أي الفيضان.
يتوقف الماء عن الارتفاع، ليصل إلى حد أقصى محلي يُسمى المد العالي.
ينخفض مستوى سطح البحر على مدار عدة ساعات، كاشفًا عن منطقة المد والجزر؛ أي الانحسار.
تُعرف التيارات المتذبذبة الناتجة عن المد والجزر باسم تيارات المد والجزر. تُسمى لحظة توقف تيار المد والجزر “المد الراكد”. ثم يعكس المد اتجاهه ويُقال إنه في حالة انعطاف. عادةً ما يحدث الماء الراكد بالقرب من منسوبي المد والجزر المرتفع والمنخفض، ولكن هناك مواقع تختلف فيها لحظات الجزر الراكد بشكل كبير عن لحظات المد والجزر المرتفع والمنخفض.
عادةً ما يكون المد والجزر شبه يومي (ارتفاعان وانخفاضان يوميًا)، أو يومي (دورة مد وجزر واحدة يوميًا). عادةً ما يختلف ارتفاعا أعلى مستوىين في يوم معين (التفاوت اليومي)؛ وهما أعلى مستوى وأدنى مستوى في جداول المد والجزر. وبالمثل، فإن أدنى مستوى يوميًا هو أعلى مستوى وأدنى مستوى. التفاوت اليومي غير ثابت، وعادةً ما يكون صغيرًا عندما يكون القمر فوق خط الاستواء.
مستويات مرجعية Reference levels
The following reference tide levels can be defined, from the highest level to the lowest:
Highest astronomical tide (HAT) – The highest tide which can be predicted to occur. Note that meteorological conditions may add extra height to the HAT.
Mean high water springs (MHWS) – The average of the two high tides on the days of spring tides.
Mean high water neaps (MHWN) – The average of the two high tides on the days of neap tides.
Mean sea level (MSL) – This is the average sea level. The MSL is constant for any location over a long period.
Mean low water neaps (MLWN) – The average of the two low tides on the days of neap tides.
Mean low water springs (MLWS) – The average of the two low tides on the days of spring tides.
Lowest astronomical tide (LAT) – The lowest tide which can be predicted to occur.
يمكن تعريف مستويات المد والجزر المرجعية التالية، من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى:
أعلى مد فلكي (HAT) – أعلى مد يمكن التنبؤ بحدوثه. تجدر الإشارة إلى أن الظروف الجوية قد تزيد من ارتفاع HAT.
متوسط إرتفاع الماء الكبير (MHWS) – متوسط المد والجزر في أيام المد الربيعي.
متوسط إرتفاع الماء الصغير (MHWN) – متوسط المد والجزر في أيام المد القريب.
متوسط مستوى سطح البحر (MSL) – متوسط مستوى سطح البحر. يبقى مستوى سطح البحر ثابتًا لأي موقع على مدى فترة زمنية طويلة.
متوسط إنخفاض الماء الصغير (MLWN) – متوسط المد والجزر في أيام المد القريب.
متوسط إنخفاض الماء الكبير (MLWS) – متوسط المد والجزر في أيام المد الربيعي.
أدنى مد فلكي (LAT) – أدنى مد يمكن التنبؤ بحدوثه.
تنوع النطاق: الينابيع والرواسب Range variation: springs and neaps
يختلف المدى شبه اليومي (الفرق في الارتفاع بين المياه العالية والمنخفضة على مدار نصف يوم تقريبًا) في دورة مدتها أسبوعان. مرتين تقريبًا في الشهر، حول المحاق والبدر، عندما تُشكّل الشمس والقمر والأرض خطًا مستقيمًا (يُعرف باسم الاقتران)، تُعزز قوة المد والجزر الناتجة عن الشمس قوة المد والجزر الناتجة عن القمر. عندها، يبلغ مدى المد والجزر ذروته؛ ويُسمى هذا بالمد الربيعي. لم يُسمَّ هذا المد والجزر نسبةً إلى الفصل، ولكنه، مثل هذه الكلمة، مُشتق من معنى “القفز، الانفجار، الارتفاع”، كما هو الحال في الربيع الطبيعي. يُشار أحيانًا إلى المد والجزر الربيعي باسم مد الاقتران.
عندما يكون القمر في الربع الأول أو الربع الثالث، تكون الشمس والقمر مفصولين بزاوية 90 درجة عند رؤيتهما من الأرض (في التربيع)، وتُلغي قوة المد والجزر الشمسية جزئيًا قوة مد القمر. عند هذه النقاط من الدورة القمرية، يكون مدى المد والجزر في أدنى مستوياته؛ يُطلق على هذا المد والجزر المنخفض (Neaps). “Neap” كلمة أنجلو ساكسونية تعني “بدون قوة”، كما في forðganges nip (المضي قدمًا بدون قوة). يُشار أحيانًا إلى المد المنخفض بالمد التربيعي.
يؤدي المد الربيعي إلى ارتفاع منسوب المياه أعلى من المتوسط، وانخفاض منسوب المياه أقل من المتوسط، وفترة “ركود” أقصر من المتوسط، وتيارات مد وجزر أقوى من المتوسط. أما المد المنخفض فيؤدي إلى ظروف مد وجزر أقل تطرفًا. هناك فاصل زمني يبلغ حوالي سبعة أيام بين الينابيع والمد المنخفض.
مكونات المد والجزر Tidal constituents
مكونات المد والجزر هي النتيجة النهائية لتأثيرات متعددة تؤثر على تغيرات المد والجزر على مدى فترات زمنية محددة. تشمل المكونات الرئيسية دوران الأرض، وموقع القمر والشمس بالنسبة للأرض، وارتفاع القمر فوق خط استواء الأرض، وقياس الأعماق. تُسمى التغيرات التي تقل فتراتها عن نصف يوم مكونات توافقية. في المقابل، تُسمى دورات الأيام أو الأشهر أو السنوات مكونات طويلة الأمد.
تؤثر قوى المد والجزر على الأرض بأكملها، لكن حركة الأرض الصلبة تحدث ببضع سنتيمترات فقط. في المقابل، يكون الغلاف الجوي أكثر سيولة وقابلية للانضغاط، لذا يتحرك سطحه كيلومترات، بمعنى مستوى كفاف ضغط منخفض معين في الغلاف الجوي الخارجي.
المكون القمري شبه اليومي الرئيسي Principal lunar semi-diurnal constituent
المدة: 31 ثانية. 0:31
الارتفاع العالمي لسطح المد والجزر المحيطي M2 (ناسا)
في معظم المواقع، يُعدّ المكون القمري شبه اليومي الرئيسي، والمعروف أيضًا باسم المكون المدّي M2 أو المكون المدّي M2، أكبر مكون. تبلغ مدته حوالي 12 ساعة و25.2 دقيقة، أي نصف يوم قمري مدّي بالضبط، وهو متوسط الوقت الذي يفصل بين سمت قمري وآخر، وبالتالي فهو الوقت اللازم لدوران الأرض مرة واحدة بالنسبة للقمر. تتبع ساعات المد والجزر البسيطة هذا المكون. اليوم القمري أطول من يوم الأرض لأن القمر يدور في نفس اتجاه دوران الأرض.
يدور القمر حول الأرض في نفس اتجاه دوران الأرض حول محورها، لذلك يستغرق القمر أكثر بقليل من يوم واحد – حوالي 24 ساعة و50 دقيقة – للعودة إلى نفس الموقع في السماء. خلال هذه الفترة، مرّ القمر فوق الأرض (ذروته) مرة، وتحت الأرض مرة (بزاوية ساعة 00:00 و12:00 على التوالي)، لذا فإن فترة أقوى تأثير مدّي في العديد من الأماكن هي المذكورة أعلاه، أي حوالي 12 ساعة و25 دقيقة. لا يعني ذروة المد بالضرورة أن يكون القمر أقرب إلى السمت أو الحضيض، ولكن فترة التأثير تُحدد الوقت بين المد والجزر.
ولأن مجال الجاذبية الذي يُحدثه القمر يضعف مع البعد عن القمر، فإنه يُمارس قوة أكبر بقليل من المتوسط على جانب الأرض المُواجه للقمر، وقوة أضعف بقليل على الجانب المُقابل. وبالتالي، يميل القمر إلى “تمديد” الأرض قليلاً على طول الخط الواصل بين الجسمين. تتشوه الأرض الصلبة قليلاً، لكن مياه المحيط، لكونها سائلة، تكون حرة الحركة بشكل أكبر استجابةً لقوة المد والجزر، وخاصةً أفقيًا (انظر المد والجزر المتوازن).
مع دوران الأرض، يتغير مقدار واتجاه قوة المد والجزر عند أي نقطة على سطح الأرض باستمرار؛ ورغم أن المحيط لا يصل إلى حالة التوازن أبدًا – إذ لا يتوفر وقت كافٍ للسائل ليعود إلى حالته التي كان سيصل إليها لو ظلت قوة المد والجزر ثابتة – إلا أن قوة المد والجزر المتغيرة تُسبب تغيرات منتظمة في ارتفاع سطح البحر.
ثلاثة رسوم بيانية. يُظهر الأول نمط المد والجزر مرتين يوميًا، مع ارتفاعات شبه منتظمة. يُظهر الثاني المد والجزر المتغيرين بشكل كبير، واللذين يُشكلان “مدًا مختلطًا”. يُظهر الثالث فترة المد النهاري التي تستمر طوال اليوم.
أنواع المد والجزر (انظر التوقيت (أدناه) لخريطة السواحل)
عندما يكون هناك مدان عاليان كل يوم بارتفاعات مختلفة (ومد وجزران منخفضان بارتفاعات مختلفة أيضًا)، يُسمى هذا النمط مدًا شبه يومي مختلط.
المسافة القمرية Lunar distance
يؤثر تغيّر المسافة الفاصلة بين القمر والأرض أيضًا على ارتفاعات المد والجزر. فعندما يكون القمر في أقرب نقطة له، عند الحضيض، يزداد نطاقه، وعندما يكون في الأوج، يتقلص نطاقه. يتزامن الحضيض ست أو ثماني مرات سنويًا مع قمر جديد أو بدر، مما يتسبب في حدوث مد ربيعي حضي ذي نطاق مدّي أوسع. ويعتمد الفرق بين ارتفاع المد عند المد الربيعي الحضيض والمد الربيعي عندما يكون القمر في الأوج على الموقع، ولكنه قد يكون كبيرًا جدًا، إذ قد يصل إلى إرتفاع أعلى.
عوامل أخرى Other constituents
تشمل هذه العوامل تأثيرات الجاذبية الشمسية، وميلان خط استواء الأرض ومحور دورانها، وميل مستوى مدار القمر، والشكل الإهليلجي لمدار الأرض حول الشمس.
ينتج المد المركب (أو المد الزائد) عن تفاعل موجتيه الأم في المياه الضحلة.
تاريخ
تاريخ نظرية المد والجزر
كان للبحث في فيزياء المد والجزر أهمية بالغة في المراحل المبكرة من تطور ميكانيكا الأجرام السماوية، حيث فُسِّر وجود مدَّين يوميين بجاذبية القمر. لاحقًا، فُسِّر المد والجزر اليومي بدقة أكبر من خلال تفاعل جاذبية القمر مع الشمس.
وضع سلوقس السلوقي Seleucus of Seleucia نظريةً حوالي عام 150 قبل الميلاد تُشير إلى أن القمر هو سبب المد والجزر. كما ذُكر تأثير القمر على المسطحات المائية في كتاب بطليموس “الرباعيات”.
في كتابه “حساب الزمن” (De temporum ratione) لعام 725، ربط بيدي المد والجزر شبه الدوري وظاهرة ارتفاعات المد والجزر المتغيرة بالقمر ومراحله. بدأ بيدي بالإشارة إلى أن المد والجزر يرتفعان وينخفضان متأخرين 4/5 ساعة كل يوم، تمامًا كما يشرق القمر ويغرب متأخرًا 4/5 ساعة. ثم أكد على أنه في شهرين قمريين (59 يومًا) يدور القمر حول الأرض 57 مرة ويوجد 114 مدًا. ثم لاحظ بيدي أن ارتفاع المد والجزر يختلف على مدار الشهر. تسمى المد والجزر المتزايد malinae والمد والجزر المتناقص ledones وأن الشهر مقسم إلى أربعة أجزاء من سبعة أو ثمانية أيام مع تناوب malinae وledones. في نفس المقطع، لاحظ أيضًا تأثير الرياح في كبح المد والجزر. سجل بيدي أيضًا أن وقت المد والجزر يختلف من مكان لآخر. شمال موقع بيدي (مونكويرماوث)، يكون المد والجزر أبكر، وجنوبه متأخرًا. ويوضح أن المد “يهجر هذه الشواطئ ليتمكن من إغراق الشواطئ الأخرى عند وصوله إليها”، مشيرًا إلى أن “القمر الذي يُشير إلى ارتفاع المد هنا، يُشير إلى تراجعه في مناطق أخرى بعيدة عن هذا الربع من السماء”.
استند فهم المد والجزر في العصور الوسطى اللاحقة بشكل أساسي إلى أعمال علماء الفلك المسلمين، والتي أصبحت متاحة من خلال الترجمات اللاتينية بدءًا من القرن الثاني عشر. ذكر أبو معشر البلخي (توفي حوالي عام 886)، في كتابه “مقدمة في علم الفلك”، أن القمر هو سبب المد والجزر. ناقش أبو معشر آثار الرياح وأطوار القمر بالنسبة للشمس على المد والجزر. في القرن الثاني عشر، ساهم البترجي (توفي حوالي عام 1204) بفكرة أن المد والجزر ناتجان عن الدورة العامة للسماء.
نفى سيمون ستيفين، في كتابه “نظرية المد والجزر” الصادر عام 1608، عددًا كبيرًا من المفاهيم الخاطئة التي كانت لا تزال سائدة حول المد والجزر. دافع ستيفين عن فكرة أن جاذبية القمر مسؤولة عن المد والجزر، وتحدث بوضوح عن المد والجزر والمد الربيعي والمد المنخفض، مؤكدًا على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث.
في عام 1609 اقترح يوهانس كيبلر أيضًا بشكل صحيح أن جاذبية القمر تسبب المد والجزر،والذي استند فيه إلى الملاحظات والارتباطات القديمة.
في كتابه “حوار حول النظامين العالميين الرئيسيين” الصادر عام ١٦٣٢، والذي كان عنوانه العملي “حوار حول المد والجزر”، قدّم غاليليو غاليلي شرحًا لظاهرة المد والجزر. إلا أن النظرية الناتجة كانت خاطئة، إذ نسب المد والجزر إلى تناثر الماء الناتج عن حركة الأرض حول الشمس. وكان يأمل في تقديم دليل ميكانيكي على حركة الأرض. إلا أن قيمة نظريته حول المد والجزر محل جدل. وقد رفض غاليليو تفسير كبلر لظاهرة المد والجزر.
كان إسحاق نيوتن (١٦٤٢-١٧٢٧) أول من فسّر المد والجزر على أنه ناتج عن قوة الجذب الثقالي للكتل الفلكية. نُشر شرحه للمد والجزر (والعديد من الظواهر الأخرى) في كتابه “المبادئ” (1687)، واستخدم نظريته في الجاذبية الكونية لشرح قوى الجذب القمرية والشمسية باعتبارها أصل قوى توليد المد والجزر.[هـ] عمل نيوتن وآخرون قبل بيير سيمون لابلاس على هذه المشكلة من منظور نظام ثابت (نظرية التوازن)، والذي قدم تقريبًا يصف المد والجزر الذي سيحدث في محيط غير بالقصور الذاتي يغطي الأرض بأكملها بالتساوي. لا تزال قوة توليد المد والجزر (أو إمكاناتها المقابلة) ذات صلة بنظرية المد والجزر، ولكن ككمية وسيطة (دالة إجبارية) بدلاً من كونها نتيجة نهائية؛ يجب أن تأخذ النظرية أيضًا في الاعتبار استجابة المد والجزر الديناميكية المتراكمة للأرض للقوى المطبقة، والتي تتأثر هذه الاستجابة بعمق المحيط ودوران الأرض وعوامل أخرى.
في عام 1740، قدمت الأكاديمية الملكية للعلوم في باريس جائزة لأفضل مقال نظري عن المد والجزر. تقاسم الجائزة كلٌ من دانيال برنولي، وليونارد أويلر، وكولين ماكلورين، وأنطوان كافاليري.
استخدم ماكلورين نظرية نيوتن لإثبات أن الكرة الملساء المغطاة بمحيط عميق بما فيه الكفاية، تحت تأثير قوة المد والجزر لجسم مشوه واحد، هي كروية متمددة (بيضاوية ثلاثية الأبعاد في جوهرها) ذات محور رئيسي موجه نحو الجسم المشوه. كان ماكلورين أول من كتب عن تأثيرات دوران الأرض على الحركة. أدرك أويلر أن المركبة الأفقية لقوة المد والجزر (أكثر من المركبة الرأسية) هي التي تحرك المد والجزر. في عام ١٧٤٤، درس جان لو روند دالمبير معادلات المد والجزر للغلاف الجوي التي لم تتضمن الدوران.
في عام ١٧٧٠، جنحت سفينة جيمس كوك “إتش إم إس إنديفور” على الحاجز المرجاني العظيم. بُذلت محاولات لإعادة تعويمها في المد التالي، لكنها باءت بالفشل، لكن المد الذي تلاه رفعها بسهولة. أثناء إصلاحها في مصب نهر إنديفور، رصد كوك المد والجزر على مدى سبعة أسابيع. في المد القريب، كان المد والجزر متشابهين في اليوم الواحد، ولكن في الينابيع، ارتفع المد والجزر بمقدار 2.1 متر (7 أقدام) صباحًا و2.7 متر (9 أقدام) مساءً.
صاغ بيير سيمون لابلاس نظامًا من المعادلات التفاضلية الجزئية يربط التدفق الأفقي للمحيط بارتفاع سطحه، وهي أول نظرية ديناميكية رئيسية لمد وجزر المياه. لا تزال معادلات لابلاس للمد والجزر مستخدمة حتى اليوم. أعاد ويليام طومسون، بارون كلفن الأول، كتابة معادلات لابلاس من حيث الدوامة، مما أتاح حلولًا لوصف الأمواج المحاصرة الساحلية التي يدفعها المد والجزر، والمعروفة باسم أمواج كلفن.
وطوّر آخرون، بمن فيهم كلفن وهنري بوانكاريه، نظرية لابلاس. وبناءً على هذه التطورات ونظرية القمر التي وضعها إي دبليو براون والتي تصف حركات القمر، قام آرثر توماس دودسون في عام 1921 بتطوير ونشر أول تطوير حديث لإمكانية توليد المد والجزر في شكل متناغم: حيث ميز دودسون 388 ترددًا للمد والجزر. ولا تزال بعض أساليبه قيد الاستخدام.
تاريخ رصد المد والجزر History of tidal observation
تقويم بروسكون لعام ١٥٤٦: اتجاهات البوصلة لأعالي البحار في خليج بسكاي (يسار) والساحل من بريتاني إلى دوفر (يمين).
تقويم بروسكون لعام ١٥٤٦: مخططات المد والجزر “حسب عمر القمر”.
منذ العصور القديمة، ازدادت مراقبة المد والجزر تعقيدًا، حيث ركّزت في البداية على تكرار حدوثه يوميًا، ثم على علاقته بالشمس والقمر. سافر بيثياس إلى الجزر البريطانية حوالي عام ٣٢٥ قبل الميلاد، ويبدو أنه أول من ربط المد الربيعي بأطوار القمر.
في القرن الثاني قبل الميلاد، وصف عالم الفلك الهلنستي سلوقس السلوقي ظاهرة المد والجزر وصفًا دقيقًا لدعم نظريته حول مركزية الشمس. وقد افترض نظريًا أن القمر هو سبب المد والجزر، مع اعتقاده بأن التفاعل بينهما يحدث بواسطة النَفَس. لاحظ أن المد والجزر يختلفان من حيث الوقت والقوة في مختلف أنحاء العالم. ووفقًا لسترابو (1.1.9)، كان سلوقس أول من ربط المد والجزر بجاذبية القمر، وأن ارتفاع المد والجزر يعتمد على موقع القمر بالنسبة للشمس.
يجمع كتاب “التاريخ الطبيعي” لبليني الأكبر العديد من ملاحظات المد والجزر، على سبيل المثال، يحدث المد الربيعي بعد (أو قبل) المحاق والبدر ببضعة أيام، ويكون في أعلى مستوياته حول الاعتدالين، مع أن بليني أشار إلى العديد من العلاقات التي تُعتبر الآن خيالية. في كتابه “الجغرافيا”، وصف سترابو المد والجزر في الخليج العربي بأنه يبلغ أقصى مداه عندما يكون القمر في أبعد نقطة عن مستوى خط الاستواء. كل هذا على الرغم من صغر سعة المد والجزر في حوض البحر الأبيض المتوسط نسبيًا. (أثارت التيارات القوية عبر مضيق يوريبوس ومضيق ميسينا حيرة أرسطو). ناقش فيلوستراتوس المد والجزر في الكتاب الخامس من “حياة أبولونيوس التياني”. يذكر فيلوستراتوس القمر، لكنه ينسب المد والجزر إلى “الأرواح”. في أوروبا حوالي عام 730 ميلادي، وصف القديس بيدا كيف يتزامن ارتفاع المد على أحد سواحل الجزر البريطانية مع انخفاضه على الساحل الآخر، ووصف التقدم الزمني لارتفاع منسوب المياه على طول ساحل نورثامبريا.
سُجِّل أول جدول مد وجزر في الصين عام ١٠٥٦ ميلاديًا، وكان الغرض الرئيسي منه هو مُخصَّصًا للزوار الراغبين في رؤية منسوب المد والجزر الشهير في نهر تشيانتانغ. ويُعتقد أن أول جدول مد وجزر بريطاني معروف هو جدول جون والينغفورد، الذي تُوفي رئيسًا لدير سانت ألبانز عام ١٢١٣، استنادًا إلى ارتفاع منسوب المياه الذي يحدث متأخرًا بـ ٤٨ دقيقة يوميًا، وقبل ثلاث ساعات عند مصب نهر التايمز منه عند منبعه في لندن.
في عام ١٦١٤، نشر كلود دابفيل كتابه “تاريخ بعثة آباء الكبوشيين في جزيرة ماراجنان والأراضي المحيطة”، حيث كشف أن شعب توبينامبا كان لديه فهمٌ للعلاقة بين القمر والمد والجزر قبل أوروبا.
قاد ويليام طومسون (اللورد كلفن) أول تحليل توافقي منهجي لسجلات المد والجزر، بدءًا من عام ١٨٦٧. وكانت النتيجة الرئيسية بناء آلة للتنبؤ بالمد والجزر باستخدام نظام بكرات لجمع ست دوال زمنية توافقية. وقد تمت “برمجتها” بإعادة ضبط التروس والسلاسل لضبط الطور والسعات. واستمر استخدام آلات مماثلة حتى ستينيات القرن العشرين.
تم تسجيل أول سجل معروف لمستوى سطح البحر لدورة ربيعية-مُنخفضة كاملة عام ١٨٣١ على رصيف البحرية في مصب نهر التايمز. بحلول عام ١٨٥٠، كانت العديد من الموانئ الكبيرة مزودة بمحطات قياس مد وجزر آلية.
كان جون لوبوك من أوائل من رسموا خرائط خطوط المد والجزر المشتركة، لبريطانيا العظمى وأيرلندا والسواحل المجاورة، عام ١٨٤٠. وسّع ويليام ويويل هذا العمل ليُنجز خريطة شبه عالمية عام ١٨٣٦. ولجعل هذه الخرائط متسقة، افترض وجود منطقة لا تشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في المد والجزر، حيث تلتقي خطوط المد والجزر المشتركة في منتصف المحيط. وقد أكد الكابتن ويليام هيويت، من البحرية الملكية، وجود هذه النقطة البرمائية، كما تُعرف الآن، عام ١٨٤٠، من خلال عمليات سبر دقيقة في بحر الشمال.
بعد ذلك بكثير، في أواخر القرن العشرين، لاحظ الجيولوجيون إيقاعات المد والجزر، التي تُوثّق حدوث المد والجزر القديم في السجل الجيولوجي، لا سيما في العصر الكربوني.
الفيزياء Physics
النظرية الأساسية للمدّ والجزر Basic theory of two tides
يُفسَّر مدُّ المحيط تحت سطح القمر بكون جاذبية القمر أقوى على المحيط الأقرب إليه. أما المدُّ على الجانب الآخر، فيمكن تفسيره إما بقوة الطرد المركزي نتيجة دوران الأرض حول مركز الثقل، أو بقصور الماء الذاتي، حيث تكون جاذبية القمر أقوى على الأرض الصلبة القريبة منه، ويبتعد عن الماء الأبعد. وبصفته سائلاً، يستجيب المحيط لمزيج قوى الجاذبية والطرد المركزي بشكل أكبر بكثير من الأرض الصلبة.
القوى Forces
قوة المد والجزر التي يُحدثها جسم ضخم (القمر، فيما يلي) على جسيم صغير يقع على أو داخل جسم ضخم (الأرض، فيما يلي) هي الفرق المتجهي بين قوة الجاذبية التي يُمارسها القمر على الجسيم، وقوة الجاذبية التي ستُمارس عليه إذا كان موجودًا في مركز كتلة الأرض.
بينما تتغير قوة الجاذبية التي يُمارسها جسم سماوي على الأرض عكسيًا مع مربع المسافة بينه وبين الأرض، تتغير قوة المد والجزر القصوى عكسيًا مع مكعب هذه المسافة تقريبًا. إذا كانت قوة المد والجزر التي يُسببها كل جسم مساوية لقوة جاذبيته الكاملة (وهو ليس الحال بسبب السقوط الحر للأرض بأكملها، وليس فقط المحيطات، نحو هذه الأجسام)، فسيُلاحظ نمط مختلف من قوى المد والجزر، على سبيل المثال. بتأثير أقوى بكثير من الشمس منه من القمر: قوة الجاذبية الشمسية على الأرض أقوى بمتوسط 179 مرة من القمر، ولكن لأن الشمس أبعد بمتوسط 389 مرة عن الأرض، فإن تدرج مجالها أضعف. التناسب الكلي هو
حيث M هي كتلة الجسم السماوي، وd هي بعده، وρ هي متوسط كثافته، وr هو نصف قطره. ترتبط النسبة r/d بالزاوية التي يُحيط بها الجسم في السماء. ولأن قطر الشمس والقمر متساوٍ تقريبًا في السماء، فإن قوة المد والجزر للشمس أقل من قوة القمر لأن متوسط كثافتها أقل بكثير، وهي لا تتجاوز 46% من حجم القمر وبالتالي، خلال المد الربيعي، يُساهم القمر بنسبة 69% بينما تُساهم الشمس بنسبة 31%. بتعبير أدق، يبلغ تسارع المد والجزر القمري (على طول محور القمر-الأرض، عند سطح الأرض) حوالي 1.1×10−7 ج، بينما يبلغ تسارع المد والجزر الشمسي (على طول محور الشمس-الأرض، عند سطح الأرض) حوالي 0.52×10−7 ج، حيث ج هو تسارع الجاذبية عند سطح الأرض. تختلف تأثيرات الكواكب الأخرى باختلاف مسافاتها عن الأرض. عندما يكون كوكب الزهرة في أقرب نقطة من الأرض، يكون تأثيره 0.000113 ضعف التأثير الشمسي. في أوقات أخرى، قد يكون للمشتري أو المريخ التأثير الأكبر.
يُقارب سطح المحيط سطح يُشار إليه باسم الجيود، والذي يأخذ في الاعتبار قوة الجاذبية التي تمارسها الأرض بالإضافة إلى قوة الطرد المركزي الناتجة عن الدوران. الآن، ضع في اعتبارك تأثير الأجسام الخارجية الضخمة مثل القمر والشمس. تتمتع هذه الأجسام بحقول جاذبية قوية تتضاءل مع المسافة وتتسبب في انحراف سطح المحيط عن الجيود. إنها تُنشئ سطح محيط متوازنًا جديدًا ينتفخ باتجاه القمر من جانب وبعيدًا عن القمر من الجانب الآخر. يتسبب دوران الأرض بالنسبة لهذا الشكل في دورة المد والجزر اليومية. يميل سطح المحيط نحو شكل التوازن هذا، والذي يتغير باستمرار، ولا يصل إليه أبدًا. عندما لا يكون سطح المحيط محاذيًا له، يكون الأمر كما لو كان السطح مائلًا، ويتسارع الماء في اتجاه المنحدر.
التوازن Equilibrium
المدّ المتوازن هو المد المثالي بافتراض خلو الأرض من اليابسة.يُنتج هذا انتفاخًا مدّيًا في المحيط، ممتدًا باتجاه الجسم الجاذب (القمر أو الشمس). لا ينتج هذا عن قوة السحب الرأسية الأقرب أو الأبعد عن الجسم، والتي تكون ضعيفة جدًا؛ بل ينتج عن قوة المد المماسية أو الجرّية، والتي تكون في أقوى حالاتها عند زاوية 45 درجة تقريبًا من الجسم، مما ينتج عنه تيار مدّ أفقي.
معادلات لابلاس للمد والجزر Laplace’s tidal equations
أعماق المحيطات أصغر بكثير من امتدادها الأفقي. وبالتالي، يمكن نمذجة الاستجابة لقوى المد والجزر باستخدام معادلات لابلاس للمد والجزر التي تتضمن الخصائص التالية:
السرعة الرأسية (أو الشعاعية) مهملة، ولا يوجد قص رأسي – وهذا ما يُعرف بالتدفق الصفحي.
القوة أفقية فقط (مماسية).
يظهر تأثير كوريوليس كقوة قصور ذاتي (وهمية) تؤثر جانبيًا على اتجاه التدفق وتتناسب طرديًا مع السرعة.
يتناسب معدل تغير ارتفاع السطح طرديًا مع التباعد السلبي للسرعة مضروبًا في العمق. عندما تمد السرعة الأفقية المحيط كصفيحة أو تضغطه، يتناقص حجمه أو يزداد سمكه، على التوالي.
تفرض الظروف الحدية عدم وجود تدفق عبر الساحل وانزلاقًا حرًا في القاع.
يوجه تأثير كوريوليس (قوة القصور الذاتي) التدفقات المتجهة نحو خط الاستواء غربًا، والتدفقات المتجهة بعيدًا عنه شرقًا، مما يسمح بتكوين أمواج محاصرة على الساحل. وأخيرًا، يمكن إضافة مصطلح التبديد، وهو مصطلح مشابه للزوجة.
السعة وزمن الدورة Amplitude and cycle time
تبلغ السعة النظرية للمد والجزر المحيطي الناتج عن القمر حوالي 54 سنتيمترًا (21 بوصة) عند أعلى نقطة، وهو ما يتوافق مع السعة التي يمكن الوصول إليها لو كان للمحيط عمق موحد، ولم تكن هناك كتل يابسة، وكانت الأرض تدور بإيقاع متزامن مع مدار القمر. وبالمثل، تُسبب الشمس المد والجزر، حيث تبلغ سعته النظرية حوالي 25 سنتيمترًا (9.8 بوصة) (46% من سعة القمر) بزمن دورة مده 12 ساعة. في المد الربيعي، يتحد التأثيران ليصلا إلى مستوى نظري قدره 79 سنتيمترًا (31 بوصة)، بينما ينخفض المستوى النظري في المد المنخفض إلى 29 سنتيمترًا (11 بوصة). ونظرًا لأن مداري الأرض حول الشمس والقمر حول الأرض بيضاويان، فإن سعات المد والجزر تتغير إلى حد ما نتيجة لاختلاف المسافة بين الأرض والشمس والأرض والقمر. يؤدي هذا إلى تباين في قوة المد والجزر والسعة النظرية بنحو ±18% للقمر و±5% للشمس. لو كان كلٌّ من الشمس والقمر في أقرب موقعين لهما ومتحاذيين عند المحاق، لبلغت السعة النظرية 93 سنتيمترًا (37 بوصة).
تختلف السعات الفعلية اختلافًا كبيرًا، ليس فقط بسبب اختلافات العمق والعوائق القارية، ولكن أيضًا لأن فترة انتشار الأمواج عبر المحيط طبيعية بنفس مقدار فترة الدوران: فلو لم تكن هناك كتل يابسة، لاستغرق انتشار موجة سطحية طويلة الطول الموجي على طول خط الاستواء في منتصف المسافة حول الأرض حوالي 30 ساعة (بالمقارنة، تبلغ فترة انتشار الغلاف الصخري للأرض حوالي 57 دقيقة). يُعدّ المد والجزر الأرضي، الذي يرفع ويخفض قاع المحيط، وجاذبية المد والجزر الذاتية، عاملين مهمين، ويُعقّدان استجابة المحيط لقوى المد والجزر.
التبديد Dissipation
تُسبب تذبذبات المد والجزر على الأرض تبديدًا بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.75 تيراوات. ويُعزى حوالي 98% من هذا التبديد إلى حركة المد والجزر البحرية. وينشأ التبديد عندما تُحرك تدفقات المد والجزر على نطاق الأحواض تدفقات أصغر نطاقًا تُعاني من تبديد مضطرب. يُولّد هذا السحب المدّي عزم دوران على القمر ينقل الزخم الزاوي تدريجيًا إلى مداره، ويزيد تدريجيًا من المسافة بين الأرض والقمر. ويُقلل عزم الدوران المساوٍ والمعاكس على الأرض من سرعة دورانها بالتبعية. وهكذا، على مدار الزمن الجيولوجي، يبتعد القمر عن الأرض بمعدل حوالي 3.8 سنتيمتر (1.5 بوصة) سنويًا، مما يُطيل اليوم الأرضي.
ازداد طول اليوم بحوالي ساعتين خلال الـ 600 مليون سنة الماضية. بالافتراض (كتقريب أولي) أن معدل التباطؤ كان ثابتًا، فهذا يعني أنه قبل 70 مليون سنة، كان طول اليوم أقصر بنحو 1% مع حوالي 4 أيام إضافية كل عام.
قياس الأعماق Bathymetry
يُغير شكل الشاطئ وقاع المحيط طريقة انتشار المد والجزر، لذا لا توجد قاعدة عامة بسيطة تُحدد وقت ارتفاع منسوب المياه من موقع القمر في السماء. تشير خصائص الساحل، مثل قياس الأعماق تحت الماء وشكل الساحل، إلى أن خصائص الموقع الفردية تؤثر على التنبؤ بالمد والجزر؛ وقد يختلف وقت ارتفاع منسوب المياه الفعلي وارتفاعه عن توقعات النماذج نظرًا لتأثير مورفولوجيا الساحل على تدفق المد والجزر. ومع ذلك، بالنسبة لموقع معين، تكون العلاقة بين ارتفاع القمر ووقت ارتفاع أو انخفاض المد (الفترة القمرية) ثابتة نسبيًا وقابلة للتنبؤ، وكذلك وقت ارتفاع أو انخفاض المد بالنسبة لنقاط أخرى على الساحل نفسه. على سبيل المثال، يحدث ارتفاع المد في نورفولك، فرجينيا، الولايات المتحدة، بشكل متوقع قبل ساعتين ونصف تقريبًا من مرور القمر فوقها مباشرةً.
تُشكّل الكتل الأرضية وأحواض المحيطات حواجز أمام حركة المياه بحرية حول العالم، ويؤثر تنوع أشكالها وأحجامها على حجم تواتر المد والجزر. ونتيجةً لذلك، تتباين أنماط المد والجزر. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يغلب على الساحل الشرقي مدٌّ شبه يومي، وكذلك سواحل أوروبا الأطلسية، بينما يغلب على الساحل الغربي مدٌّ مختلط. كما يُمكن للتغيرات البشرية في التضاريس أن تُغيّر المد والجزر المحلي بشكل كبير.
الرصد والتنبؤ Observation and prediction
التوقيت Timing
خريطة عالمية تُظهر مواقع المد والجزر اليومي، وشبه اليومي، والمختلط. السواحل الغربية الأوروبية والأفريقية شبه يومية حصريًا، والساحل الغربي لأمريكا الشمالية شبه يومي مختلط، ولكن في أماكن أخرى، تتداخل الأنماط المختلفة بشكل كبير، على الرغم من أن نمطًا معينًا قد يغطي مسافة تتراوح بين 200 و2000 كيلومتر (120-1240 ميلًا).
تختلف نتائج قوى المد والجزر نفسها تبعًا لعوامل عديدة، منها اتجاه الساحل، وحافة الجرف القاري، وأبعاد المسطحات المائية.
تُولّد قوى المد والجزر الناتجة عن القمر والشمس أمواجًا طويلة جدًا تدور حول المحيط متبعةً المسارات الموضحة في خرائط المد والجزر المشتركة. يُحدد وقت وصول قمة الموجة إلى ميناء ما وقت ارتفاع منسوب المياه عنده. كما أن الوقت الذي تستغرقه الموجة في الدوران حول المحيط يعني وجود تأخير بين مراحل القمر وتأثيرها على المد والجزر. على سبيل المثال، تتأخر الينابيع والرواسب في بحر الشمال يومين عن المحاق/البدر والتربيع الأول/الثالث للقمر. وهذا ما يُسمى بعمر المد.
يؤثر قياس أعماق المحيط بشكل كبير على الوقت الدقيق للمد والجزر وارتفاعه عند نقطة ساحلية معينة. هناك بعض الحالات المتطرفة؛ فكثيرًا ما يُقال إن خليج فندي، على الساحل الشرقي لكندا، يشهد أعلى مد وجزر في العالم نظرًا لشكله وقياس أعماقه وبعده عن حافة الجرف القاري. وقد سجلت القياسات التي أُجريت في نوفمبر 1998 في رأس بيرنتكوت في خليج فندي أقصى مدى له بلغ 16.3 مترًا (53 قدمًا)، وأعلى ارتفاع متوقع بلغ 17 مترًا (56 قدمًا). أظهرت قياسات مماثلة أُجريت في مارس 2002 في حوض ليف، بخليج أونغافا شمال كيبيك، قيمًا متشابهة (مع مراعاة أخطاء القياس)، حيث بلغ أقصى مدى للجليد 16.2 مترًا (53 قدمًا)، وأعلى ارتفاع متوقع 16.8 مترًا (55 قدمًا). يقع خليج أونغافا وخليج فندي على مسافات متشابهة من حافة الجرف القاري، إلا أن خليج أونغافا لا يخلو من الجليد المتراكم إلا لمدة أربعة أشهر تقريبًا كل عام، بينما نادرًا ما يتجمد خليج فندي.
تتميز ساوثهامبتون في المملكة المتحدة بارتفاع مائي مزدوج ناتج عن التفاعل بين مكونات المد والجزر M2 وM4 (المد والجزر الضحل للقمر الرئيسي). وللسبب نفسه، تتميز بورتلاند بانخفاض مائي مزدوج. يمتد المد M4 على طول الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة، ولكن تأثيره يكون أكثر وضوحًا بين جزيرة وايت وبورتلاند لأن المد M2 هو الأدنى في هذه المنطقة.
نظرًا لأن أنماط التذبذب في البحر الأبيض المتوسط وبحر البلطيق لا تتزامن مع أي فترة تأثير فلكي مهمة، فإن أكبر المد والجزر يكون بالقرب من اتصالاتهما الضيقة بالمحيط الأطلسي. كما يحدث مد وجزر صغير للغاية للسبب نفسه في خليج المكسيك وبحر اليابان. وفي أماكن أخرى، كما هو الحال على طول الساحل الجنوبي لأستراليا، يمكن أن يكون سبب انخفاض المد والجزر وجود قارب أمفيدروم قريب.
تحليل Analysis
مكّنت نظرية إسحاق نيوتن في الجاذبية، لأول مرة، من تفسير سبب وجود مدَّين يوميًا بشكل عام، بدلًا من مدٍّ واحد، وأعطت أملًا في فهمٍ مُفصّل لقوى المد والجزر وسلوكها. مع أنه قد يبدو من الممكن التنبؤ بالمد والجزر من خلال معرفةٍ مُفصّلةٍ بما يكفي للقوى الفلكية اللحظية، إلا أن المد والجزر الفعلي في موقعٍ مُعيّن يتحدد من خلال القوى الفلكية المُتراكمة في المسطح المائي على مدار أيامٍ عديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الحصول على نتائج دقيقة معرفةً مُفصّلةً لشكل جميع أحواض المحيطات – قياس أعماقها، وشكل خط الساحل.
يتبع الإجراء الحالي لتحليل المد والجزر طريقة التحليل التوافقي التي طرحها ويليام طومسون في ستينيات القرن التاسع عشر. يعتمد هذا على مبدأ أن النظريات الفلكية لحركات الشمس والقمر تُحدد عددًا كبيرًا من الترددات المُركّبة، وعند كل تردد توجد مُركّبة قوة تميل إلى إحداث حركة مدية، ولكن في كل نقطة مهمة على الأرض، تستجيب المد والجزر عند كل تردد بسعة وطور خاصين بتلك المنطقة. لذلك، في كل نقطة مهمة، تُقاس ارتفاعات المد والجزر لفترة زمنية كافية (عادةً ما تكون أكثر من عام في حالة ميناء جديد لم يُدرَس سابقًا) لتمكين تمييز الاستجابة عند كل تردد مُولّد كبير للمد والجزر عن طريق التحليل، واستخراج ثوابت المد والجزر لعدد كافٍ من أقوى المُركّبات المعروفة لقوى المد والجزر الفلكية لتمكين التنبؤ العملي بالمد والجزر. من المتوقع أن تتبع ارتفاعات المد والجزر قوة المد والجزر، بسعة وتأخير طور ثابتين لكل مُركّب. وبما أنه من الممكن حساب الترددات والمراحل الفلكية بشكل مؤكد، فمن الممكن بعد ذلك التنبؤ بارتفاع المد والجزر في أوقات أخرى بمجرد العثور على الاستجابة للمكونات التوافقية لقوى توليد المد والجزر الفلكية.
الأنماط الرئيسية للمد والجزر هي: The main patterns in the tides are
التغير مرتين يوميًا
الفرق بين المد الأول والثاني في اليوم
دورة الربيع-الربيع
التغير السنوي
أعلى مد فلكي هو المد الربيعي الحضيض عندما يكون كل من الشمس والقمر في أقرب نقطة من الأرض.
عند مواجهة دالة متغيرة دوريًا، فإن النهج القياسي هو استخدام متسلسلة فورييه، وهو شكل من أشكال التحليل يستخدم الدوال الجيبية كمجموعة أساسية، بترددات تساوي صفرًا، واحدًا، اثنين، ثلاثة، إلخ، مضروبًا في تردد دورة أساسية معينة. تُسمى هذه المضاعفات توافقيات التردد الأساسي، وتُسمى العملية التحليل التوافقي. إذا كانت مجموعة الدوال الجيبية الأساسية تناسب السلوك المراد نمذجته، فلا يلزم إضافة سوى عدد قليل نسبيًا من الحدود التوافقية. المسارات المدارية شبه دائرية، لذا فإن التغيرات الجيبية مناسبة للمد والجزر.
لتحليل ارتفاعات المد والجزر، يجب عمليًا استخدام أسلوب متسلسلة فورييه أكثر تفصيلًا من استخدام تردد واحد وتوافقياته. تُحلل أنماط المد والجزر إلى العديد من الجيوب الأنفية ذات الترددات الأساسية المتعددة، والتي تتوافق (كما في نظرية القمر) مع العديد من التركيبات المختلفة لحركات الأرض والقمر والزوايا التي تحدد شكل وموقع مداراتهما.
بالنسبة للمد والجزر، لا يقتصر التحليل التوافقي على التوافقيات ذات التردد الواحد. بمعنى آخر، التوافقيات هي مضاعفات للعديد من الترددات الأساسية، وليست فقط التردد الأساسي لأسلوب متسلسلة فورييه الأبسط. يتطلب تمثيلها كمتسلسلة فورييه ذات تردد أساسي واحد ومضاعفاته (الصحيحة) العديد من المصطلحات، وسيكون محدودًا للغاية في النطاق الزمني الذي ستكون صالحة له.
بدأ لابلاس، وويليام طومسون (اللورد كلفن)، وجورج داروين دراسة ارتفاع المد والجزر باستخدام التحليل التوافقي. أ. ت. وسّع دودسون نطاق عمله، مُقدّمًا ترميز دودسون العددي لتنظيم مئات الحدود الناتجة. وقد أصبح هذا النهج هو المعيار الدولي منذ ذلك الحين، وتظهر التعقيدات على النحو التالي: تُعطى قوة رفع المد نظريًا بمجموع عدة حدود. يكون كل حد من الشكل
حيث
Ao هي السعة،
ω هو التردد الزاوي، ويُقاس عادةً بالدرجات في الساعة، وهو ما يُقابل t المُقاس بالساعات،
p هو إزاحة الطور بالنسبة للحالة الفلكية عند الزمن t = 0.
يوجد حد للقمر وحد ثانٍ للشمس. يُسمى الطور p للتوافقية الأولى لحد القمر بالفترة القمرية أو فترة المد والجزر.
التحسين التالي هو استيعاب الحدود التوافقية نظرًا للشكل الإهليلجي للمدارات. للقيام بذلك، تُعتبر قيمة السعة ليست ثابتة، بل متغيرة مع الزمن، حول متوسط السعة Ao. للقيام بذلك، استبدل Ao في المعادلة أعلاه بـ A(t) حيث A هو جيب تمام آخر، مشابه للدورات وأفلاك التدوير في نظرية بطليموس. هذا يُعطي
أي قيمة متوسطة Ao مع تغير جيبي حولها مقداره Aa، وتردده ωa وطوره pa. باستبدال هذه القيمة بـ Ao في المعادلة الأصلية، نحصل على حاصل ضرب عاملي جيب التمام:
باعتبار أنه بالنسبة لأي x و y
من الواضح أن الحد المركب الذي يتضمن حاصل ضرب حدي جيب تمام، لكل منهما تردده الخاص، هو نفسه ثلاثة حدود جيب تمام بسيطة تُضاف عند التردد الأصلي، وكذلك عند الترددات التي تُمثل مجموع وفرق ترددي الحد الناتج. (ثلاثة، وليس حدين، لأن التعبير بأكمله هو…)
ضع في اعتبارك أيضًا أن قوة المد والجزر على موقع ما تعتمد أيضًا على ما إذا كان القمر (أو الشمس) فوق مستوى خط الاستواء أو تحته، وأن لهذه الصفات فتراتها الخاصة التي لا يمكن قياسها أيضًا باليوم والشهر، ومن الواضح أن العديد من التركيبات الناتجة. باختيار دقيق للترددات الفلكية الأساسية، يُوضح رقم دودسون الإضافات والاختلافات الخاصة لتشكيل تردد كل حد جيب تمام بسيط.
تذكر أن المد والجزر الفلكي لا يشمل تأثيرات الطقس. كما أن تغيرات الظروف المحلية (مثل حركة الرمال، وتجريف مصبات الموانئ، وما إلى ذلك) عن تلك السائدة وقت القياس تؤثر على التوقيت الفعلي للمد وشدته. قد تبالغ المنظمات التي تستشهد بـ”أعلى مد فلكي” لموقع ما في هذا الرقم كعامل أمان في مواجهة الشكوك التحليلية، والمسافة من أقرب نقطة قياس، والتغيرات منذ آخر وقت رصد، وهبوط الأرض، وما إلى ذلك، لتجنب المسؤولية في حال تجاوز العمل الهندسي الحد المسموح به. يلزم توخي الحذر الشديد عند تقييم حجم “الطفرة الجوية” عن طريق طرح المد الفلكي من المد المرصود.
يستخدم تحليل فورييه الدقيق لبيانات على مدى تسعة عشر عامًا (عصر بيانات المد والجزر الوطنية في الولايات المتحدة) ترددات تُسمى المكونات التوافقية للمد والجزر. يُفضل تسعة عشر عامًا لأن المواقع النسبية للأرض والقمر والشمس تتكرر تقريبًا في الدورة الميتونية التي تبلغ 19 عامًا، وهي طويلة بما يكفي لتشمل مكون المد والجزر العقدي القمري الذي يبلغ 18.613 عامًا. يمكن إجراء هذا التحليل باستخدام معرفة فترة القوة فقط، ولكن دون فهم مفصل للاشتقاق الرياضي، مما يعني أنه تم إنشاء جداول مد وجزر مفيدة لعدة قرون. يمكن بعد ذلك استخدام السعات والمراحل الناتجة للتنبؤ بالمد والجزر المتوقع. تهيمن عليها عادةً المكونات القريبة من 12 ساعة (المكونات شبه اليومية)، ولكن هناك مكونات رئيسية قريبة من 24 ساعة (يومية) أيضًا. المكونات طويلة المدى هي 14 يومًا أو كل أسبوعين وشهريًا ونصف سنويًا. سيطر المد والجزر شبه اليومي على الساحل، ولكن بعض المناطق مثل بحر الصين الجنوبي وخليج المكسيك نهارية في المقام الأول. في المناطق شبه اليومية، تختلف الفترتان الرئيسيتان M2 (القمري) وS2 (الشمسي) اختلافًا طفيفًا، بحيث تتغير الأطوار النسبية، وبالتالي سعة المد والجزر المشترك، كل أسبوعين (فترة 14 يومًا).
في رسم M2 أعلاه، يختلف كل خط مد وجزر بساعة واحدة عن جيرانه، وتُظهر الخطوط الأكثر سمكًا المد والجزر في طور التوازن عند غرينتش. تدور الخطوط حول النقاط البرمائية عكس اتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي، بحيث ينتشر المد M2 شمالًا من شبه جزيرة باجا كاليفورنيا إلى ألاسكا ومن فرنسا إلى أيرلندا. في نصف الكرة الجنوبي، يكون هذا الاتجاه مع عقارب الساعة. من ناحية أخرى، ينتشر المد M2 عكس اتجاه عقارب الساعة حول نيوزيلندا، ولكن هذا لأن الجزر تعمل كسد وتسمح للمد والجزر بارتفاعات مختلفة على الجانبين المتقابلين للجزر. (كما هو متوقع نظريًا، ينتشر المد والجزر شمالًا على الجانب الشرقي وجنوبًا على الساحل الغربي).
يُستثنى من ذلك مضيق كوك، حيث تربط تيارات المد والجزر دوريًا بين أعلى منسوب للمياه وأسفل منسوب للمياه. ويرجع ذلك إلى أن خطوط المد والجزر بزاوية 180 درجة حول خطوط المد والجزر تكون في طور متعاكس، على سبيل المثال، أعلى منسوب للمياه مقابل أدنى منسوب للمياه عند طرفي مضيق كوك. لكل مكون من مكونات المد والجزر نمط مختلف من السعات والأطوار والنقاط البرمائية، لذا لا يمكن استخدام أنماط M2 لمكونات المد والجزر الأخرى.
مثال على الحساب Example calculation
رسم بياني بخط واحد يرتفع وينخفض بين أربع قمم حول 3 وأربعة وديان حول -3
رسم بياني بخط واحد يُظهر قمم المد والجزر والوديان التي تتناوب تدريجيًا بين قمم أعلى وأسفل على مدار 14 يومًا
المد والجزر في بريدجبورت، كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة 30 يومًا
رسم بياني بخط واحد يُظهر تقلبًا سنويًا طفيفًا في المد والجزر
رسم بياني يُظهر ستة خطوط، خطان لكل مدينة من المدن الثلاث. تشهد نيلسون مدين ربيعيين شهريين، بينما تشهد كل من نابير وويلينغتون مدًا ربيعيًا واحدًا.
ولأن القمر يدور في مداره حول الأرض، وبنفس طريقة دوران الأرض، يجب أن تدور نقطة على الأرض أكثر قليلًا للحاق بالركب، بحيث لا يكون الوقت بين المد والجزر شبه اليومي 12.4206 ساعة، بل 12.4206 ساعة – أي أكثر بقليل من 25 دقيقة. القمتان غير متساويتين. يتناوب المد والجزر العاليان يوميًا في أقصى ارتفاعاتهما: ارتفاع أدنى (أقل بقليل من ثلاثة أقدام)، وارتفاع أعلى (أكثر بقليل من ثلاثة أقدام)، ثم ارتفاع أدنى مرة أخرى. وينطبق الأمر نفسه على المد المنخفض.
عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة (الشمس-الأرض-القمر، أو الشمس-القمر-الأرض)، يتحد المؤثران الرئيسيان لإنتاج المد الربيعي؛ وعندما تكون القوتان متعاكستين، كما هو الحال عندما تقترب زاوية القمر-الأرض-الشمس من تسعين درجة، ينتج المد الناقص. مع دوران القمر حول مداره، يتغير موقعه من شمال خط الاستواء إلى جنوبه. يتناقص التناوب في ارتفاعات المد والجزر، حتى يصبحا متساويين (عند الاعتدال القمري، يكون القمر فوق خط الاستواء)، ثم يتطور مرة أخرى ولكن مع القطبية الأخرى، ويتزايد إلى أقصى فرق ثم يتضاءل مرة أخرى.
التيار Current
يُعد تحليل تأثير المد والجزر على التيار أو التدفق أكثر صعوبة، كما أن جمع البيانات أصعب بكثير. ارتفاع المد والجزر هو كمية قياسية تتغير بسلاسة على مساحة واسعة. التدفق هو كمية متجهة، ذات مقدار واتجاه، وكلاهما يمكن أن يتغير بشكل كبير مع العمق وعلى مسافات قصيرة بسبب قياس الأعماق المحلي. كذلك، على الرغم من أن مركز قناة مائية هو موقع القياس الأكثر فائدة، إلا أن البحارة يعترضون عندما تعيق معدات قياس التيار المجاري المائية. قد يكون للتدفق المتدفق عبر قناة منحنية مقدار مماثل، على الرغم من أن اتجاهه يتغير باستمرار على طول القناة. ومن المثير للدهشة أن تدفقات الفيضان والمد والجزر غالبًا ما لا تكون في اتجاهين متعاكسين. يتم تحديد اتجاه التدفق من خلال شكل قناة المنبع، وليس شكل قناة المصب. وبالمثل، قد تتشكل الدوامات في اتجاه تدفق واحد فقط.
ومع ذلك، فإن تحليل تيارات المد والجزر يشبه تحليل ارتفاعات المد والجزر: ففي الحالة البسيطة، يكون تدفق الفيضان في موقع معين في اتجاه واحد في الغالب، وتدفق المد والجزر في اتجاه آخر. تُعطى سرعات الفيضان إشارة موجبة، وسرعات الجزر إشارة سالبة. ويُجرى التحليل كما لو كانت هذه هي ارتفاعات المد والجزر.
في الحالات الأكثر تعقيدًا، لا تهيمن تدفقات المد والجزر الرئيسية. بدلًا من ذلك، يرسم اتجاه التدفق ومقداره شكلًا بيضاويًا على مدار دورة المد والجزر (على رسم بياني قطبي) بدلًا من أن يرسما على طول خطوط المد والجزر. في هذه الحالة، قد يُجرى التحليل على طول أزواج من الاتجاهات، بحيث يكون الاتجاهان الرئيسي والثانوي بزوايا قائمة. كبديل، يُمكن معالجة تدفقات المد والجزر كأرقام مركبة، حيث لكل قيمة مقدار واتجاه.
تُعرض معلومات تدفق المد والجزر بشكل شائع على الخرائط البحرية، وتُعرض كجدول لسرعات التدفق واتجاهاته على فترات زمنية كل ساعة، مع جداول منفصلة للمد والجزر الربيعي والمُنخفض. ويرتبط التوقيت بارتفاع منسوب المياه في بعض الموانئ حيث يكون سلوك المد والجزر مشابهًا في النمط، وإن كان بعيدًا.
كما هو الحال مع تنبؤات ارتفاع المد، فإن تنبؤات تدفق المد، المستندة فقط إلى العوامل الفلكية، لا تأخذ في الاعتبار الظروف الجوية، مما قد يغير النتيجة تمامًا.
يُعد تدفق المد عبر مضيق كوك، الواقع بين الجزيرتين الرئيسيتين في نيوزيلندا، مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، حيث يكاد يكون المد والجزر على جانبي المضيق غير متزامنين تمامًا، بحيث يتزامن ارتفاع منسوب المياه في أحد الجانبين مع انخفاض منسوب المياه في الجانب الآخر. ينتج عن ذلك تيارات قوية، مع تغير شبه معدوم في ارتفاع المد في مركز المضيق. ومع ذلك، فرغم أن ارتفاع المد يتدفق عادةً في اتجاه واحد لمدة ست ساعات وفي الاتجاه المعاكس لمدة ست ساعات، إلا أن ارتفاعًا معينًا قد يستمر لثماني أو عشر ساعات مع إضعاف الارتفاع المعاكس. في الظروف الجوية العاصفة، قد يتم التغلب تمامًا على الارتفاع المعاكس، بحيث يستمر التدفق في نفس الاتجاه لثلاث فترات أو أكثر من الارتفاع.
من التعقيدات الأخرى لنمط تدفق مضيق كوك أن المد والجزر في الجانب الجنوبي (مثل نيلسون) يتبع دورة المد الربيعي-النايب الشائعة كل أسبوعين (كما هو الحال على طول الجانب الغربي من البلاد)، بينما يتبع نمط المد والجزر في الجانب الشمالي دورة واحدة فقط شهريًا، كما هو الحال في الجانب الشرقي: ويلينغتون ونابير.
يُظهر الرسم البياني لمد وجزر مضيق كوك بشكل منفصل ارتفاع منسوب المياه وانخفاضه ووقتهما، حتى نوفمبر 2007؛ وهذه ليست قيمًا مُقاسة، بل تُحسب من معلمات المد والجزر المُستمدة من قياسات عمرها سنوات. يُقدم الرسم البياني البحري لمضيق كوك معلومات عن تيارات المد والجزر. على سبيل المثال، يُشير إصدار يناير 1979 للإحداثيات 41°13.9′S 174°29.6′E (شمال غرب كيب تيراوهيتي) إلى التوقيتات في ويستبورت، بينما يُشير إصدار يناير 2004 إلى ويلينغتون. بالقرب من رأس تيراوهيتي في منتصف مضيق كوك، يكاد يكون اختلاف ارتفاع المد والجزر منعدمًا، بينما يصل تيار المد والجزر إلى ذروته، خاصةً بالقرب من مضيق كاروري الشهير. وبغض النظر عن تأثيرات الطقس، تتأثر التيارات الفعلية عبر مضيق كوك باختلاف ارتفاع المد والجزر بين طرفي المضيق، وكما يتضح، فإن أحد المدَّين الربيعيين فقط في الطرف الشمالي الغربي للمضيق بالقرب من نيلسون له مد ربيعي مقابل في الطرف الجنوبي الشرقي (ويلينغتون)، لذا فإن السلوك الناتج لا يتبع أيًا من الميناءين المرجعيين.
توليد الطاقة Power generation
يمكن استخراج طاقة المد والجزر بطريقتين: إدخال توربين مائي في تيار مد وجزر، أو بناء برك تُطلق/تسمح بمرور المياه عبر التوربين. في الحالة الأولى، تُحدد كمية الطاقة بالكامل بتوقيت وقوة تيار المد والجزر. ومع ذلك، قد لا تتوفر أفضل التيارات لأن التوربينات قد تعيق حركة السفن. في الحالة الثانية، تكون تكلفة بناء سدود الاحتجاز باهظة، مما يؤدي إلى تعطل دورات المياه الطبيعية تمامًا، وتعطل ملاحة السفن. مع ذلك، مع وجود برك متعددة، يمكن توليد الطاقة في أوقات محددة. حتى الآن، لا يوجد سوى عدد قليل من أنظمة توليد طاقة المد والجزر المُثبتة (أشهرها نظام لا رانس في سان مالو، فرنسا) التي تواجه العديد من الصعوبات. فإلى جانب المشكلات البيئية، تُشكل مقاومة التآكل والتلوث البيولوجي تحديات هندسية.
يشير مؤيدو طاقة المد والجزر إلى أنه، على عكس أنظمة طاقة الرياح، يُمكن التنبؤ بمستويات التوليد بشكل موثوق، باستثناء تأثيرات الطقس. في حين أن توليد الطاقة ممكن في معظم دورة المد والجزر، إلا أن التوربينات تفقد كفاءتها عمليًا عند انخفاض معدلات التشغيل. ولأن الطاقة المتاحة من التدفق تتناسب طرديًا مع مكعب سرعة التدفق، فإن فترات توليد الطاقة العالية تكون قصيرة.
الملاحة Navigation
رسم بياني يوضح أن ارتفاعات المد والجزر تدخل في حسابات البيانات المهمة قانونيًا، مثل خطوط الحدود بين أعالي البحار والمياه الإقليمية. يُظهر الرسم البياني خطًا ساحليًا نموذجيًا، مُحددًا معالم القاع، مثل الحواجز الشاطئية والسواتر، وارتفاعات المد والجزر، مثل متوسط ارتفاع المد، والمسافات من الشاطئ، مثل حد ١٢ ميلًا.
تُعدّ تدفقات المد والجزر مهمة للملاحة، وتحدث أخطاء كبيرة في تحديد المواقع إذا لم تُراعَ. كما تُعدّ ارتفاعات المد والجزر مهمة؛ فعلى سبيل المثال، تحتوي العديد من الأنهار والموانئ على حاجز ضحل عند المدخل، يمنع القوارب ذات الغاطس الكبير من الدخول عند انخفاض المد.
حتى ظهور الملاحة الآلية، كانت الكفاءة في حساب تأثيرات المد والجزر مهمة لضباط البحرية. وكانت شهادة امتحان الملازمين في البحرية الملكية تنص سابقًا على أن الضابط المُرشح قادر على “تغيير اتجاه مدّه”.
تظهر توقيتات وسرعات تدفقات المد والجزر في خرائط المد والجزر أو أطلس تيارات المد والجزر. تتوفر خرائط المد والجزر في مجموعات. يغطي كل مخطط ساعة واحدة بين ذروة مد وجزر (مع تجاهل الـ 24 دقيقة المتبقية)، ويُظهر متوسط تدفق المد والجزر لتلك الساعة. يشير السهم الموجود على مخطط المد والجزر إلى الاتجاه ومتوسط سرعة التدفق (عادةً بالعقد) للمد الربيعي والمد المنخفض. إذا لم يتوفر مخطط للمد والجزر، فإن معظم الخرائط البحرية تحتوي على “معينات مد وجزر” تربط نقاطًا محددة على المخطط بجدول يوضح اتجاه وسرعة تدفق المد والجزر.
الإجراء القياسي لمواجهة تأثيرات المد والجزر على الملاحة هو
(1) حساب “موضع تقديري” (أو DR) من مسافة الرحلة واتجاهها
(2) وضع علامة على المخطط (بعلامة زائد رأسية)
(3) رسم خط من DR في اتجاه المد والجزر.
تُحسب المسافة التي يحرك بها المد القارب على طول هذا الخط بواسطة سرعة المد والجزر، وهذا يُعطي “موضعًا تقديريًا” (أو EP) (يُشار إليه عادةً بنقطة داخل مثلث).
تُظهر الخرائط البحرية “عمق المياه المُسجل” في مواقع محددة، مع “السبر” واستخدام خطوط الكنتور الباثيمترية لرسم شكل السطح المغمور. هذه الأعماق نسبية إلى “مرجع بياني”، وهو عادةً مستوى المياه عند أدنى مد فلكي ممكن (مع أن مرجعيات أخرى تُستخدم عادةً، خاصةً تاريخيًا، وقد يكون المد والجزر أقل أو أعلى لأسباب جوية)، وبالتالي فهو أدنى عمق ممكن للمياه خلال دورة المد والجزر. قد تظهر أيضًا “ارتفاعات الجفاف” على الخريطة، وهي ارتفاعات قاع البحر المكشوف عند أدنى مد فلكي.
تُدرج جداول المد والجزر أعلى وأدنى ارتفاعات المياه وأوقاتها اليومية. لحساب عمق المياه الفعلي، يُضاف العمق المدرج في الخريطة إلى ارتفاع المد والجزر المنشور. يمكن حساب عمق الأوقات الأخرى من منحنيات المد والجزر المنشورة للموانئ الرئيسية. يمكن الاكتفاء بقاعدة الاثني عشر في حال عدم توفر منحنى دقيق. يفترض هذا التقريب أن الزيادة في العمق خلال الساعات الست بين منسوب المياه المنخفض والمرتفع هي: الساعة الأولى — 1/12، الثانية — 2/12، الثالثة — 3/12، الرابعة — 3/12، الخامسة — 2/12، السادسة — 1/12.
الجوانب البيولوجية Biological aspects
علم البيئة المدية Intertidal ecology
معلومات إضافية: منطقة المد والجزر
علم بيئة المد والجزر هو دراسة النظم البيئية الواقعة بين خطي المد والجزر على طول الشاطئ. عند انخفاض المد، تكون منطقة المد والجزر مكشوفة (أو غاطسة)، بينما عند ارتفاع المد، تكون تحت الماء (أو مغمورة). لذلك، يدرس علماء بيئة المد والجزر التفاعلات بين الكائنات الحية المدية وبيئتها، وكذلك التفاعلات بين الأنواع المختلفة. قد تختلف أهم التفاعلات وفقًا لنوع مجتمع المد والجزر. وتستند التصنيفات الأوسع إلى الركائز – شاطئ صخري أو قاع لين.
تعيش الكائنات الحية المدية في بيئة شديدة التقلب، وغالبًا ما تكون معادية، وقد تكيفت للتعامل مع هذه الظروف، بل وحتى استغلالها. ومن السمات الواضحة بسهولة التقسيم الرأسي، حيث ينقسم المجتمع إلى نطاقات أفقية مميزة من أنواع محددة عند كل ارتفاع فوق مستوى المد والجزر. تحدد قدرة النوع على التعامل مع الجفاف حده الأقصى، بينما تحدد المنافسة مع الأنواع الأخرى حده الأدنى.
يستخدم البشر مناطق المد والجزر للغذاء والترفيه. يمكن أن يُلحق الاستغلال المفرط ضررًا مباشرًا بمنطقة المد والجزر. كما أن للأنشطة البشرية الأخرى، مثل إدخال الأنواع الغازية وتغير المناخ، آثارًا سلبية كبيرة. تُعدّ المناطق البحرية المحمية أحد الخيارات التي يُمكن للمجتمعات تطبيقها لحماية هذه المناطق ودعم البحث العلمي.
الإيقاعات البيولوجية Biological rhythms
لدورة المد والجزر، التي تستمر ١٢ ساعة تقريبًا وتتكرر كل أسبوعين، آثار كبيرة على الكائنات البحرية بين المد والجزر. ولذلك، تميل إيقاعاتها البيولوجية إلى الظهور في مضاعفات تقريبية لهذه الفترات. تُظهر العديد من الحيوانات الأخرى، مثل الفقاريات، إيقاعات دائرية مماثلة. ومن الأمثلة على ذلك الحمل وتفقيس البيض. أما لدى البشر، فتستمر الدورة الشهرية شهرًا قمريًا تقريبًا، وهو مضاعف زوجي لفترة المد والجزر. تُشير هذه التشابهات على الأقل إلى الأصل المشترك لجميع الحيوانات من سلف بحري.
مد وجزر البحيرات Lake tides
يمكن أن تشهد البحيرات الكبيرة مثل سوبيريور وإيري مدًا وجزرًا يتراوح بين 1 و4 سم (0.39 إلى 1.6 بوصة)، ولكن يمكن إخفاء هذه المد والجزر من خلال ظواهر ناجمة عن الأرصاد الجوية مثل المد والجزر. يُوصف المد والجزر في بحيرة ميشيغان بأنه يتراوح بين 1.3 و3.8 سم (0.5 إلى 1.5 بوصة) أو 4.4 سم (1+3⁄4 بوصة). هذا المد والجزر صغير جدًا لدرجة أن التأثيرات الأكبر الأخرى تخفي أي مد وجزر تمامًا، وبالتالي تُعتبر هذه البحيرات غير مدية.
المد والجزر الجوي Atmospheric tides
تُهمل ظاهرة المد والجزر الجوي عند مستوى سطح الأرض وارتفاعات الطيران، إذ تحجبها تأثيرات الطقس الأكثر أهمية. وتنبع ظاهرة المد والجزر الجوي من الجاذبية والحرارة، وهي الديناميكية السائدة على ارتفاع يتراوح بين 80 و120 كيلومترًا (50 إلى 75 ميلًا)، حيث تصبح الكثافة الجزيئية فوقها منخفضة جدًا بحيث لا تدعم سلوك السوائل.
المد والجزر الأرضي Earth tides
يؤثر المد والجزر الأرضي، أو المد الأرضي، على كتلة الأرض بأكملها، وهو ما يشبه جيروسكوبًا سائلًا ذا قشرة رقيقة جدًا. تتحرك قشرة الأرض (داخلًا/خارجًا، شرقًا/غربًا، شمالًا/جنوبًا) استجابةً لجاذبية القمر والشمس، ومد وجزر المحيطات، والحمل الجوي. ورغم أن سعة المد والجزر الأرضي شبه اليومية ضئيلة في معظم الأنشطة البشرية، إلا أنها قد تصل إلى حوالي 55 سنتيمترًا (22 بوصة) عند خط الاستواء – 15 سنتيمترًا (5.9 بوصة) بسبب الشمس – وهو أمر مهم في معايرة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وقياسات VLBI. تتطلب القياسات الزاوية الفلكية الدقيقة معرفة معدل دوران الأرض وحركة القطبين، وكلاهما يتأثر بمد وجزر الأرض. يتزامن مد وجزر الأرض شبه اليومي (M2) تقريبًا مع القمر بفارق زمني يبلغ حوالي ساعتين.
المد والجزر المجري Galactic tides
المد والجزر المجري هو قوى المد والجزر التي تمارسها المجرات على النجوم داخلها وعلى المجرات التابعة التي تدور حولها. يُعتقد أن تأثيرات المد والجزر المجري على سحابة أورت في النظام الشمسي تُسبب 90% من المذنبات طويلة الأمد.
تسميات خاطئة Misnomers
تُسمى أحيانًا أمواج تسونامي، وهي الأمواج العاتية التي تحدث بعد الزلازل، بموجات المد، ولكن هذا الاسم يُطلق عليها لتشابهها مع المد، وليس لأي علاقة سببية به. من الظواهر الأخرى التي لا علاقة لها بالمد والجزر، والتي تستخدم كلمة “مد”، المد الصاعد، ومد العاصفة، ومد الإعصار، والمد الأسود أو الأحمر. العديد من هذه الاستخدامات تاريخية، وتشير إلى المعنى السابق للمد على أنه “جزء من الوقت، فصل” و”جدول، تيار، أو فيضان”.
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المد والجزر (المدر) Tides
المصادر: